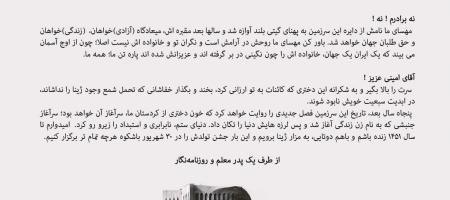عندما قدّم المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون فيلمه "روما" قبل أربع سنوات، كانت الأفلام التي يستعير فيها المخرجون المؤلفون عناصر من سيرهم الذاتية، بهدف بناء عالم خيالي انطلاقاً من تفاصيل معيشة، غائبة عن الشاشة منذ فترة. وبهذا المعنى، شرّع كوارون الطريق مجدداً لنوع سينمائي وقع في النسيان على مدى العقود الأخيرة، على رغم أنه كان رائجاً في مرحلة ما، مع أمثال فيلليني وبرغمان وتروفو ويوسف شاهين وغيرهم من الذين وظفوا تجربتهم الحياتية في سبيل الفن. في هذا الإطار، شكّل "روما" عودة كوارون إلى الينبوع، أي إلى المكسيك التي كان هاجرها سينمائياً منذ 2001، ليصوّر أفلامه بعيداً منها. لكن عندما لبّى نداء الحنين إلى الوطن، عاد إليه ليموضع كاميراه في عاصمة المكسيك المعششة بالحكايات. أما على مستوى الزمن، فكانت نقلة إلى السبعينيات، تلك الحقبة المرتبطة مباشرة بطفولة المخرج المولود عام 1961، وكذلك بالذكريات التي عاشها خلال صباه. نساء يدرن شؤون منزل بورجوازي كبير، من تربية أولاد واهتمام بهم وتدبير أمور الحياة اليومية، أصبحن في فيلم كوارون مدخلاً للحديث عن الخادمة كليو (من السكّان الأصليين للمكسيك)، الشخصية التي استلهمها كوارون من المربية التي كانت تهتم به في طفولته.
مع "آل فايبلمان" الذي نال أخيراً جائزة الجمهور في مهرجان تورونتو، على أن يصل إلى صالات السينما التجارية قبل نهاية هذا العام، يعود ستيفن سبيلبرغ إلى سيرته الشخصية، في خمسينيات القرن الماضي وستينياته. وهي في الواقع شبه سيرة، متداخلة مع السينما، وذلك من خلال قصة سامي فايبلمان المهووس بالأفلام الذي يعي وهو في عمر المراهقة، أهمية السينما في البحث عن الحقيقة واكتشافها. صحيح أن معظم أفلام مخرج "إي تي" فيها تلميحات إلى سيرته التي كانت دائماً مصدر إلهامه، لكنه هذه المرة يتطرق إليها مباشرة وبلا مواربة، مما يجعل عمله هذا أكثر أعماله شخصيةً، إذ يستند فيه إلى تفاصيل من طفولته التي عاشها في أريزونا، وكانت السينما يومذاك شغفه الأكبر. ينبش سبيلبرغ مجدداً في تيمة العائلة التي شكلت أحد أركان سينماه، بكل ما تعنيه من اضطرابات، نظراً لما عاشه من ظرف عائلي، نتيجة طلاق والديه، وأيضاً بسبب ما عاشه في المدرسة من اضطهاد لكونه يهودياً. يستعيد الفيلم التجربة الإنسانية التي جعلت من سبيلبرغ المخرج الكبير الذي نعرفه. مع ذلك، ليست الحكاية حكايته حرفياً، والفيلم شبه سيرة لا سيرة مطابقة للواقع، وهذا ما يسمح للمخرج أن يبقى على مسافة من الحقيقة، مطعّماً إياها بعناصر درامية.
بعدما قضى أكثر من نصف قرن يتناول حكايات الآخرين، شعر سبيلبرغ بحاجة ملحة إلى الحديث عن ذاته والنبش في دفاتره، وهو على مشارف الثمانين، في مبادرة يقوم بها عادة مَن يريدون ختم مسيرتهم. إلا أن هذه الفرضية تبقى مستبعدة في حال سبيلبرغ الذي لا يزال نشيطاً ويأتي بتحفة سينمائية، مرة أو مرتين في كل عقد. وينبغي التذكير أن والد المخرج، أرنولد سبيلبرغ، رحل قبل عامين عن عمر 103 سنوات، وهذا ما بثّ فيه ربما الرغبة في الوقوف عند تجربته. تعطل الحياة بسبب تفشي الوباء، كان له أيضاً تأثير في استعجال المشروع، وهي فترة يقول عنها سبيلبرغ بأنها وفرت للناس الكثير من الوقت والكثير من الخوف في آن. أما علاقته بكاتب السيناريو توني كوشنر، فيقارنها بالعلاقة بين المريض والمعالج.
المخرج الإيطالي باولو سورنتينو اختار بدوره السيرة الذاتية غير التقليدية، ولو أنه لا يزال في الثانية والخمسين من العمر، مما يؤكد أن رغبة المخرجين في الحديث عن ذاتهم ليست وقفاً على عمر معين، على رغم أن قصّة كقصته، مع ما تتطلبه من بُعد، ما كانت لتروى قبل الخمسين. وهو العمر الذي اكتشف فيه سورنتينو أن حياته الماضية انطوت على لحظات حب ولحظات ألم، وأنه نتاج هذا وذاك. الحديث هنا عن فيلمه الأخير، "كانت يد الله"، الذي عُرض العام الماضي، وهو يستعيد فيه سيرته في نابولي الثمانينيات، أيام البراءة وولادة الأحاسيس الأولى. لكن خلافاً لسبيلبرغ، فإن الحكي عن كرة القدم هو الغالب، أما السينما فتأتي في مرحلة لاحقة من حياة سورنتينو الذي فتح عينيه على حب اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا (يستوحي عنوان الفيلم من عبارته الشهيرة)، يوم كان يلعب في نادي نابولي. في سيرة ذاتية تمزج بين الشخصي والوجداني والعائلي، يسجل المخرج عودة إلى مسقطه الذي لم يفارقه قط. فمَن ولد وعاش في نابولي قد يغادرها يوماً، لكن المكان لن يغادره، وهذا ما يقوله فيلم سورنتينو الذي ظل ينجز أفلاماً هنا وهناك، قبل أن يلجأ إلى هذه السيرة المتخيلة على طريقة فيلليني، تماماً كما فعل المعلم عندما صوّر "أماركورد" في مدينته ريميني. ولعل أهم ما في الفيلم هو أنه يشكّل مدخلاً إلى عالم سورنتينو السينمائي، فيتعمّق فهمنا له ويتوضح كلّ ما كان غامضاً أو ناقصاً في سيرته. الفيلم يجعلنا نتضامن معه ونشعر بما مر به من فصل مؤلم في حياته، يوم خسر والديه اللذين قضيا في حادث تسرب مواد كيماوية قاتلة خلال عطلتهما الصيفية، حين كان هو بعيداً منهما. يعترف سورنتينو أنه أنجز هذا الفيلم كي ينسى ما عاشه، أو على الأقل جزءاً ممّا عاشه، محولاً الشاشة إلى مصح.
مع "يوم هرمغدون"، يستعيد المخرج الأميركي جيمس غراي فصولاً من طفولته المشاغبة في نيويورك الثمانينيات، عندما كان رونالد ريغان رئيساً. عنوان الفيلم ما هو سوى عبارة مستعارة من خطاب ريغان تحدث فيه عن صراع الخير والشر. الزمن الذي ينقلنا إليه غراي زمن صعب اجتماعياً وسياسياً، ولكن كما في حال سورنتينو، فالفيلم يغدو سريعاً "خريطة طريق" لسينما غراي، لكونه يروي فصلاً من فصول الاختلاف، التيمة التي انطوت عليها أفلام المخرج النيويوركي. الطفولة التي سنشهد عليها تفقد براءتها تدريجاً لحظة دخولها عالم الكبار. سبق لغراي أن تناول شيئاً من سيرته في فيلمه "المهاجر" المستمد من ذكريات جدَّيه الأوكرانيين الروسيين اللذين وصلا إلى أميركا في العشرينيات. لكن لم يكن الفيلم المذكور، بالمباشرة التي هو عليها هنا. البيئة اليهودية التي يتحدر منها غراي شأنه شأن زميله سبيلبرغ، هي أيضاً الحضن الدافئ للفيلم، وتتجلى من خلال اللقاءات العائلية المتكررة، وأيضاً من خلال السلوكيات وأنماط التفكير التي تصبح تحصيلاً حاصلاً لدى الأقليات الدينية. الصبي الذي يلعب دور غراي وهو طفل ينشأ وفي داخله حب للفن، مما يجعله مختلفاً عن بقية الأولاد، ووضعه هذا في مواجهة أهله وخصوصاً الأب القاسي والمتسلط الذي لا يتردد في تعنيفه. هذه تجربة حياتية لا بد أنها صنعت السينمائي الذي تحوله غراي لاحقاً وأسست للتيمة الأساسية التي دار عليها معظم أفلام غراي: العلاقة الإشكالية بالأب (السلطة). لكن مقابل هذا الصراع بين جيلين، هناك حكاية إنسان ينقذه الفن، وهذا ما يرويه الفيلم الذي يعري مخرجه تماماً. هناك مَن شبّه "يوم هرمغدون" بـ"الحياة الماجنة" لتروفو، لما نراه من معاناة وقسوة، تصنعان شخصية صبي يحلم بالفن والسينما. وهذا ليس مستغرباً عندما نتذكّر كم أن غراي من المتأثرين بالموجة الفرنسية الجديدة.
العودة إلى المكسيك وباللغة الإسبانية بعد مجموعة أفلام هوليوودية، هي ما أقدم عليه المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليث إينياريتو الذي غاب عن السينما منذ ست سنوات، في جديده "باردو". ست سنوات كانت فترة ضرورية لتختمر الفكرة في ذهن المخرج. فما يرويه هنا ليس مجرد قصة كغيرها من القصص، إنما حصيلة تجربة حياتية وفنية يضعها الفنان في فيلمه الطموح هذا، مستوحياً من سيرته، لكن ليس على طريقة أي من السينمائيين الذين ذكرتهم آنفاً.
من خلال شخصية الصحافي الذي أضحى "أناه الأخرى"، يتأمل إينياريتو في تاريخ بلاده، قافزاً بين المراحل والأمكنة. يبحث هذا الصحافي الذي يتسكع داخل سيرته وسيرة بلاده عن أجوبة لأسئلة وهواجس لم يحلها، وهي ظلت مؤجلة من جيل إلى جيل، من لحظة تاريخية إلى أخرى. علاقته بالأشياء شبيهة بعلاقة إينياريتو بأشيائه، فهما مكسيكيان نالا الشهرة والمجد في أميركا، وهما يطرحان أسئلة عن الهوية والمستقبل في عمر معين.
الممثل والمخرج البريطاني كينيث برانا مثال آخر عن كيفية الحديث عن الذات من خلال الفيلم السينمائي المعاصر. كان برانا في الثامنة عندما اندلعت شرارة الصراع القومي في إيرلندا الشمالية ليستمر 30 عاماً. هذه هي الحقبة التي يعود إليها في فيلمه "بلفاست". مدينة بلفاست التي سلبت منه، ظلت تسكنه طويلاً على حد تعبيره، وبعد عدد من الأفلام كان لا بد من التطرق إلى هذا النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت. هذا كله من خلال شخصية الصبي بادي الذي لا يعرف في بداية الصراع شيئاً عن السياسة، بل كل ما يشغله هو الكرة والسينما والبنت التي وقع في غرامها. ولكن مع تطور الأحداث، يداهمه القلق فيبدأ تدريجاً في فقدان براءته.
كل شيء بالنسبة لبرانا بدأ مع تصاعد أعمال العنف في شهر أغسطس (آب) من عام 1969. منذ تلك اللحظة وحياة عائلته البروتستانتية انقلبت رأساً على عقب. "وكأن الأرض انسحبت من تحت أقدامنا" يقول في مقابلة. "حتى الأرصفة في مكان إقامتنا، تم تكسيرها وكنا نمشي على الرمل. كل ما كنا نعرفه اختفى".
انطلاقاً من هذه التجربة المأسوية أنجز برانا فيلمه، بعدما خطرت الفكرة في باله وهو في الحجر الصحي. أراد أن يفهم أي صبي كانه، وأي رجل أصبحه بعد مرور عقود على طفولته المعذبة. اتمام سيناريو الفيلم الذي أنهاه قبل فترة قصيرة من بلوغه الستين، أضحى لحظة تحرر عند فنان دخل مرحلة النضج والحكمة، وهو يؤكد اليوم أن نظرة الآخرين إليه لا تعود بتلك الأهمية بعد تجاوز الستين من العمر. يروي برانا أنه خلال عرض الفيلم، توجهت له شقيقته بملاحظة: "مقارنة برجل لطالما كان حريصاً على عدم عرض حياته الشخصية، كشفتَ الكثير عن نفسك في هذا الفيلم". وهذا إن دل على شيء، فإنما على أن الفنان مهما تكتم، لا بد أن يأتي اليوم الذي سيحرر فيه نفسه من خلال فنه.